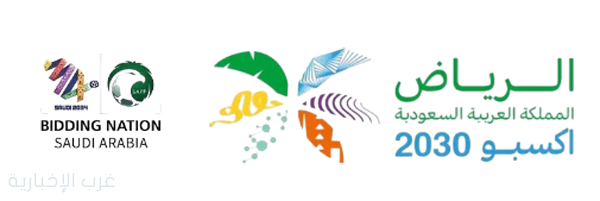المصدر -
-من هي رقية عبدالجبار بعيدًا عن الألقاب؟ وكيف تخدمي اهتمامك بالصحة النفسية عبر الكتابة والإعلام؟
بدايتي مع الكتابة كانت في عمر الثانية عشرة، تحديدًا في لحظة من الخيبة الصادمة التي شعرت فيها بأن العالم من حولي فجأةً أصبح بلا لغة أستطيع التعبير من خلاله. لم تكن لدي أدوات آنذاك لفهم ما حدث، ولا مساحة كافية للصراخ أو البكاء. كانت الأوراق والقلم هما الشيئان الوحيدان اللذان لم يختصراني، ولم يقولا لي "هذا ليس شيئًا"، أو "كُبرْ". اكتشفت، دون أن أخطط، أن الكتابة كانت الفعل الوحيد الذي يجعل الفوضى الداخلية قابلة للملاحظة، بل وللترتيب.
لم أبدأ بكتابة "نص" بالمعنى الأدبي، بل بدأت بسكب كلمات مكسورة، وجمل غير مكتملة، كما لو أن يدي كانت تترجم إشاراتٍ عاطفيةٍ لم أكن أفهمها. كان هديرًا على الورق. ثم، ببطء، تحول هذا السكب إلى حوار مع الذات. كانت الكتابة هي المنفذ الذي حوّل الصمت إلى صوت، والانفعال إلى معنى. ومن ذلك اليوم، لم يعد القلم مجرد أداة، بل أصبح شريكًا في الفهم، وشاهدًا على ما لا يُقال في العلن.
هذه التجربة المبكرة علمتني درسًا أساسيًا أرافقني حتى اليوم: أن الكتابة، في جوهرها الأولي، هي فعل بقاء. هي طريقة نصنع بها لأنفسنا ملجأً من اللغة عندما تشتدّ العواصف الداخلية أو الخارجية. وهذا بالضبط ما أحاول، لاحقًا عبر الإعلام والكتابة الواعية، أن أقدم جزءًا منه للآخرين: مساحة لغوية آمنة، حيث تكون الكلمات جسرًا للفهم، لا حاجزًا، ووسيلة لاستعادة السلطة على السرد الشخصي لكل إنسان.
-متى بدأت علاقتك مع الكتابة، وما الذي دفعك للتعبير بالكلمة لأول مرة؟
العلاقة بين الفكرة والشكل الأدبي بالنسبة لي ليست علاقة اختيار واعٍ بقدر ما هي عملية استماع حدسي. أشبهها بلحظة التقاط الذبذبة الصحيحة؛ كل فكرة، أو شعور، أو صورة عالقة في الذهن، تأتي وهي تحمل في داخلها نغمةً خاصة، وإيقاعًا يجعلها تميل بشكل طبيعي نحو وعاء التعبير الأنسب لها.
أحيانًا، تأتي الفكرة مُكثّفةً وحادّةً كالومضة، تحتاج إلى ومضة مماثلة في الرد: الفلاش. هو الومضة التي تلتقط صورة ذهنية كاملة، أو مفارقة عميقة، في سطور قليلة لا تحتمل الزيادة.
وأحيانًا أخرى، تأتي الفكرة كحاجةٍ للشرح، أو التأمل الهادئ، أو بناء حجة عقلانية ووجدانية متسقة. هنا يكون الشعر او النثر هو الملاذ، لأنه يمنح المساحة للتفصيل والتشعب والوصول إلى طبقات أعمق من الفهم، دون حاجة إلى الإيقاع أو القافية، بل بإيقاع الفكرة نفسها.
عمليًا، أنا لا أتعمد التصنيف مسبقًا. بل أدع المادة الخام (الموقف، الشعور، التساؤل) تفرض طبيعتها. دوري هو أن أكون مستقبلاً حساسًا وناقلًا أمينًا يحاول ألا يشوّش على النغمة الأصلية للفكرة. هذا التحرر من القيود الشكلية الصارمة هو ما يحافظ على صدق التعبير وحيويته. فهو يسمح للرسالة أن تختار ثوبها الخاص، مما يجعلها أقرب إلى المتلقي وأكثر قدرة على تحقيق الهدف الأسمى: الوصول، والفهم، وخلق ذلك الأثر الهادئ في النفس. في النهاية، كل هذه الأشكال هي مجرد أوعية مختلفة لخدمة جوهر واحد: الكلمة الصادقة.
- كيف تتعاملين مع التردد أو فقدان الإلهام أثناء الكتابة؟
أتعامل مع لحظات التردد أو فقدان الإلهام ليس كعدوّ، بل كدلالة لطيفة من داخلي على حاجتي إلى توقف مؤقت. عندما أشعر أن الكلمات تتباعد، أو أن الجمل تفقد رونقها، لا أقاوم.. أتوقف.
أقوم بتحضير فنجان القهوة المفضل لديّ، ليس كمجرد مشروب، بل كطقس هادئ للانتقال من فضاء الكتابة إلى فضاء الاستراحة. أجلس في زاويتي الهادئة، وأسمح لنفسي بأن أكون ببساطة حاضرةً مع رائحة القهوة، ودَفْء الكوب بين يديّ، وصمت اللحظة.
في هذا الاستكنان، لا أحاول ملاحقة الإلهام، بل أدعه هو يتراخى ويعود في وقته. أمنح ذهني مساحةً ليتنفس من غير مهمة، لأشعر بطاقتي تعود تدريجيًا كمدّ البحر الهادئ. أجد أن هذا الابتعاد الواعي هو في جوهره جزءٌ من الكتابة نفسها؛ فهو يطهّر المساحة الداخلية حتى تعود الكلمات صافيةً، مقبلةً من تلقاء نفسها.
هذه اللحظات ليست فراغًا، بل هي الهدوء الذي يسبق الكلمة، والسكون الذي يمنح الإيقاع معنى. وبعدها، غالبًا ما أعود إلى الصفحة بذهنٍ أكثر صفاءً، وقلبٍ أكثر اتصالًا بما أريد قوله حقًا.
ما الأثر الذي تتمنين أن يتركه نصك فى القارئ، وأين ترين نفسك كتابياً فى الفترة القادمة؟
فيما يخصّ الأثر الذي أتمناه، هو أثر هادئ ومضيء. لا أطمح إلى نصّ عاصف أو صادم، بل إلى أن يكون كلامي كالنافذة المفتوحة على مهبّ نسيم ناعم. أتمنى أن يجد القارئ في كلماتي مساحةً للتوقف، والتذكّر، والمصالحة مع جزء من ذاته. أن يشعر بأن مشاعره مسموحة، وأنه ليس وحيدًا في بحثه عن معنى أو سلام. شعار "نعم للحياة" هو خلاصة ذلك الأثر: ليس تفاؤلاً سطحيًا، بل قرارًا واعيًا بالحضور الكامل في عالمنا، بكل ما فيه من تعقيد وجمال. جودة الحياة الصحيحة تبدأ من هنا، من هذه اللفتة الداخلية نحو القبول والأمل.
أما عن مكاني الكتابي في الفترة القادمة، فأرى نفسي في حالة استكشاف دائمة، لكن هذه الرحلة بدأت تأخذ ملامح أكثر وضوحًا على الخريطة. ما زلت أبحر في محيط واسع من الجمال والخيال والأسئلة الإنسانية العميقة، وهذا الإبحار هو الذي يقود المشاريع القادمة. هناك ترتيبات عملية تحت السطح، أهمها العمل على إتمام روايتي الأولى، التي تكون حصيلة تأملات متراكمة، وإصدار ديوانٍ يجمع شتات كتاباتي الشعرية والنثرية في إطارٍ واحد، كنقطة التقاء في رحلتي المستمرة.
الكتابة ليست وجهةً أصل إليها، بل هي الرحلة ذاتها. هذه المشاريع هي محطاتٌ على الدرب، وأنا ممتنةٌ لكل خطوة، وأتطلع إلى مشاركة ما يثمره هذا السير مع قرائي، مع الحفاظ على الهدوء والصدق كبوصلةٍ ترشد كل كلمة.
بدايتي مع الكتابة كانت في عمر الثانية عشرة، تحديدًا في لحظة من الخيبة الصادمة التي شعرت فيها بأن العالم من حولي فجأةً أصبح بلا لغة أستطيع التعبير من خلاله. لم تكن لدي أدوات آنذاك لفهم ما حدث، ولا مساحة كافية للصراخ أو البكاء. كانت الأوراق والقلم هما الشيئان الوحيدان اللذان لم يختصراني، ولم يقولا لي "هذا ليس شيئًا"، أو "كُبرْ". اكتشفت، دون أن أخطط، أن الكتابة كانت الفعل الوحيد الذي يجعل الفوضى الداخلية قابلة للملاحظة، بل وللترتيب.
لم أبدأ بكتابة "نص" بالمعنى الأدبي، بل بدأت بسكب كلمات مكسورة، وجمل غير مكتملة، كما لو أن يدي كانت تترجم إشاراتٍ عاطفيةٍ لم أكن أفهمها. كان هديرًا على الورق. ثم، ببطء، تحول هذا السكب إلى حوار مع الذات. كانت الكتابة هي المنفذ الذي حوّل الصمت إلى صوت، والانفعال إلى معنى. ومن ذلك اليوم، لم يعد القلم مجرد أداة، بل أصبح شريكًا في الفهم، وشاهدًا على ما لا يُقال في العلن.
هذه التجربة المبكرة علمتني درسًا أساسيًا أرافقني حتى اليوم: أن الكتابة، في جوهرها الأولي، هي فعل بقاء. هي طريقة نصنع بها لأنفسنا ملجأً من اللغة عندما تشتدّ العواصف الداخلية أو الخارجية. وهذا بالضبط ما أحاول، لاحقًا عبر الإعلام والكتابة الواعية، أن أقدم جزءًا منه للآخرين: مساحة لغوية آمنة، حيث تكون الكلمات جسرًا للفهم، لا حاجزًا، ووسيلة لاستعادة السلطة على السرد الشخصي لكل إنسان.
-متى بدأت علاقتك مع الكتابة، وما الذي دفعك للتعبير بالكلمة لأول مرة؟
العلاقة بين الفكرة والشكل الأدبي بالنسبة لي ليست علاقة اختيار واعٍ بقدر ما هي عملية استماع حدسي. أشبهها بلحظة التقاط الذبذبة الصحيحة؛ كل فكرة، أو شعور، أو صورة عالقة في الذهن، تأتي وهي تحمل في داخلها نغمةً خاصة، وإيقاعًا يجعلها تميل بشكل طبيعي نحو وعاء التعبير الأنسب لها.
أحيانًا، تأتي الفكرة مُكثّفةً وحادّةً كالومضة، تحتاج إلى ومضة مماثلة في الرد: الفلاش. هو الومضة التي تلتقط صورة ذهنية كاملة، أو مفارقة عميقة، في سطور قليلة لا تحتمل الزيادة.
وأحيانًا أخرى، تأتي الفكرة كحاجةٍ للشرح، أو التأمل الهادئ، أو بناء حجة عقلانية ووجدانية متسقة. هنا يكون الشعر او النثر هو الملاذ، لأنه يمنح المساحة للتفصيل والتشعب والوصول إلى طبقات أعمق من الفهم، دون حاجة إلى الإيقاع أو القافية، بل بإيقاع الفكرة نفسها.
عمليًا، أنا لا أتعمد التصنيف مسبقًا. بل أدع المادة الخام (الموقف، الشعور، التساؤل) تفرض طبيعتها. دوري هو أن أكون مستقبلاً حساسًا وناقلًا أمينًا يحاول ألا يشوّش على النغمة الأصلية للفكرة. هذا التحرر من القيود الشكلية الصارمة هو ما يحافظ على صدق التعبير وحيويته. فهو يسمح للرسالة أن تختار ثوبها الخاص، مما يجعلها أقرب إلى المتلقي وأكثر قدرة على تحقيق الهدف الأسمى: الوصول، والفهم، وخلق ذلك الأثر الهادئ في النفس. في النهاية، كل هذه الأشكال هي مجرد أوعية مختلفة لخدمة جوهر واحد: الكلمة الصادقة.
- كيف تتعاملين مع التردد أو فقدان الإلهام أثناء الكتابة؟
أتعامل مع لحظات التردد أو فقدان الإلهام ليس كعدوّ، بل كدلالة لطيفة من داخلي على حاجتي إلى توقف مؤقت. عندما أشعر أن الكلمات تتباعد، أو أن الجمل تفقد رونقها، لا أقاوم.. أتوقف.
أقوم بتحضير فنجان القهوة المفضل لديّ، ليس كمجرد مشروب، بل كطقس هادئ للانتقال من فضاء الكتابة إلى فضاء الاستراحة. أجلس في زاويتي الهادئة، وأسمح لنفسي بأن أكون ببساطة حاضرةً مع رائحة القهوة، ودَفْء الكوب بين يديّ، وصمت اللحظة.
في هذا الاستكنان، لا أحاول ملاحقة الإلهام، بل أدعه هو يتراخى ويعود في وقته. أمنح ذهني مساحةً ليتنفس من غير مهمة، لأشعر بطاقتي تعود تدريجيًا كمدّ البحر الهادئ. أجد أن هذا الابتعاد الواعي هو في جوهره جزءٌ من الكتابة نفسها؛ فهو يطهّر المساحة الداخلية حتى تعود الكلمات صافيةً، مقبلةً من تلقاء نفسها.
هذه اللحظات ليست فراغًا، بل هي الهدوء الذي يسبق الكلمة، والسكون الذي يمنح الإيقاع معنى. وبعدها، غالبًا ما أعود إلى الصفحة بذهنٍ أكثر صفاءً، وقلبٍ أكثر اتصالًا بما أريد قوله حقًا.
ما الأثر الذي تتمنين أن يتركه نصك فى القارئ، وأين ترين نفسك كتابياً فى الفترة القادمة؟
فيما يخصّ الأثر الذي أتمناه، هو أثر هادئ ومضيء. لا أطمح إلى نصّ عاصف أو صادم، بل إلى أن يكون كلامي كالنافذة المفتوحة على مهبّ نسيم ناعم. أتمنى أن يجد القارئ في كلماتي مساحةً للتوقف، والتذكّر، والمصالحة مع جزء من ذاته. أن يشعر بأن مشاعره مسموحة، وأنه ليس وحيدًا في بحثه عن معنى أو سلام. شعار "نعم للحياة" هو خلاصة ذلك الأثر: ليس تفاؤلاً سطحيًا، بل قرارًا واعيًا بالحضور الكامل في عالمنا، بكل ما فيه من تعقيد وجمال. جودة الحياة الصحيحة تبدأ من هنا، من هذه اللفتة الداخلية نحو القبول والأمل.
أما عن مكاني الكتابي في الفترة القادمة، فأرى نفسي في حالة استكشاف دائمة، لكن هذه الرحلة بدأت تأخذ ملامح أكثر وضوحًا على الخريطة. ما زلت أبحر في محيط واسع من الجمال والخيال والأسئلة الإنسانية العميقة، وهذا الإبحار هو الذي يقود المشاريع القادمة. هناك ترتيبات عملية تحت السطح، أهمها العمل على إتمام روايتي الأولى، التي تكون حصيلة تأملات متراكمة، وإصدار ديوانٍ يجمع شتات كتاباتي الشعرية والنثرية في إطارٍ واحد، كنقطة التقاء في رحلتي المستمرة.
الكتابة ليست وجهةً أصل إليها، بل هي الرحلة ذاتها. هذه المشاريع هي محطاتٌ على الدرب، وأنا ممتنةٌ لكل خطوة، وأتطلع إلى مشاركة ما يثمره هذا السير مع قرائي، مع الحفاظ على الهدوء والصدق كبوصلةٍ ترشد كل كلمة.