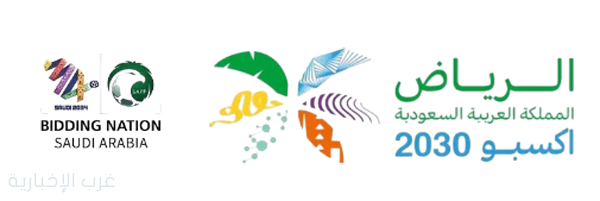المصدر -
أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، المسلمين بتقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه وتجنب مساخطه ومناهيه .
وقال فضيلته: “تتعاقَب الأيامُ، وتتوالى الشّهورُ، وتمضي السُّنون، والأعمارُ تُطوَى، والآجالُ تُقضى، والأبدانُ تَبلَى، وكلُّ شيءٍ بأجلٍ مسمَّى، وها نحنُ قدْ ودعنَا عاماً تقضَّتْ ساعاتُهُ سِراعاً، ومضتْ أوقاتُهُ تِباعاً، وكأنَّها طيفُ خيالٍ، أو ضيفٌ زارَ ثمَّ زالَ، وفي استقبالِ عامٍ وتوديعِ آخَرَ تذكرةٌ للمتدبِّرين وعبرةٌ للمتفكرين، قال تعالى {يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ} ، والبصيرُ لا يركنُ إلى الخُدعِ، ولا يغترُ بالطمعِ، ومن أطالَ الأملَ نسِيَ العملَ، وغفلَ عن الأجلِ، والعاقلُ الحَصيفُ هو مَنْ يتَّخِذُ مِنْ صفَحاتِ الدَّهرِ وانطوائِهِ وقفاتٍ للمحاسبةِ الجادَّةِ، ولحظاتٍ للمُراجعةِ الصّادقةِ، فيرتقي في مراتبِ الكمالِ البشـري الذي أمرَهُ اللهُ بنشدانِهِ، وشَحَذَ الهِمَمَ للسعيّ في بنائِهِ وإتقانِهِ” .
وأشار الدكتور الدوسري إلى أن كلِّ مُكلَّفٍ عَاقِلٍ، وحَتمٌ على كلِّ مُوقنٍ حَازمٍ، وأن يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ لا يغفلَ عنْ مُحاسبةِ نفسِهِ، ومُراجعةِ وتقييمِ مَسارِهِ في ماضِيهِ وحَاضرِهِ ومُستقبلِهِ .
وقال: ” في حوادثِ الأيامِ عِبَرٌ، وفي قوارعِ الدهرِ مُزدَجَرٌ، فالفُرَصُ تَفوتُ، والأجلُ مَوقوتُ، والإقامةُ محدودَةٌ، والأيّامُ معدودةٌ، موضحاً أنَّ هلاكَ القلبِ وأضرَّ ما يكونُ على الإنسانِ: الإهمالُ وتركُ المحاسبةِ، والاسترسالُ وموافقةُ النفسِ واتباعُ هواهَا، فإنَّ هذا يؤولُ بهِ إلى الهلاكِ، وهذه حالُ أهلِ الغرورِ، يُغمضُ عينيهِ عنِ العواقبِ ويتكلُ على العفو، فإذا فعلَ ذلك سهلَ عليهِ مُواقعةُ الذنوبِ وأَنِسَ بها، وعَسرَ عليه فِطامُها، وأنَّ النفسَ خُلقتْ أمارةً بالسوءِ تجري بطبعِهَا في ميدانِ المخالفةِ، وقدْ أُمِرَ العبدُ بتقويمِهَا وتزكيتِهَا، وأنْ يقودَهَا بسلاسلِ القهرِ إلى عبادةِ ربِّهَا، فإنْ أهملَهَا وأغفلَهَا جمحَتْ وشردَتْ وتمردَّتْ، ولم يظفرْ بهَا بعدَ ذلك، وإن قوّمَهَا وحاسبَهَا ارتدعَتْ وأذعنَتْ واستقامَتْ”.
وأضاف فضيلته : “وإذا عَرَفَ الإنسانُ عيوبَ نفسِهِ وآفاتِهَا دفعَهُ ذلك إلى مَقتِهَا، والتذللِ والخضوعِ بينَ يَدي خالقِهَا، كما يدعوهُ ذلكَ إلى محاسبةِ نفسِهِ ومجاهدتِهَا، وتطهيرِهَا مِنَ الذنوبِ، وتنقيتِهَا مِنَ العيوبِ، وتزكيتِهَا طاعةً لعلّامِ الغيوبِ، راجياً بذلك الفوزَ والفلاحَ” .
وذكر إمام وخطيب المسجد الحرام أن السلف الصلح – رحمهم اللهُ – أدركَ هذه المعاني، وقدروهَا حقَّ قدرِهَا، فترجموهَا في حياتِهِم قولاً وعملاً، مبيناً أن التاريخُ سطَّرَ لهمْ أروعَ الوصايا وأعظمَها في هذا الميدانِ، واستفاضتْ مقولاتُهُم وسارتْ بهَا الركبانُ، ومِنْ ذلك الأثرُ الشهيرُ عنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه حينَ قالَ: ( حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ).
وأوضح فضيلة الدكتور الدوسري أنَّ محاسبةَ النفسِ كما تكونُ بعدَ العملِ فإنَّها تكونُ قبلَهُ وفي أثنائِهِ، فأمَّا محاسبتُهَا قبلَ العملِ فيكونُ بالوقوفِ عندَ أولِ همِّهِ وإرادتِهِ، ولا يُبادرُ بالعملِ حتى يتبينَ لهُ رجحانُ العملِ بهِ على تركِهِ، قالَ الحسنُ: ( رَحِمَ اللهُ عبداً وقفَ عندَ همِّهِ، فإنْ كانَ للهِ مَضَى، وإنْ كانَ لغيرِهِ تأخَرَ)، وأما محاسبةُ النَّفسِ في أثنائِهِ فتكونُ بالاجتهادِ في تحقيقِ الإخلاصِ والمتابعةِ في العملِ حتى يفرَغَ منهُ ، وأما محاسبتُهَا بعدَ العملِ فتكونُ بالنظرِ في الفرائضِ والأوامرِ، فإنْ رأى فيهَا نقصاً بذلَ جهدَهُ، واستعانَ بربِهِ في تتميمِهِ وتكميلِهِ، وإتقانِهِ، ثم ينظرُ في المناهِي، فإنْ عَرَفَ أنَّهُ ارتكبَ منهَا شيئاً تداركَهُ بالإقلاعِ والتوبةِ النصوحِ والاستغفارِ والحسناتِ الماحيةِ، والإعراضِ عنِ الأسبابِ الموصلةِ إليه.
وأبان فضيلته أن شهرَ اللهِ المحرمِ شهرٌ رفيعُ القَدْرِ، عظيمُ الأجرِ، والصومُ فيه عبادةٌ جليلةٌ، والإكثارُ منه قربةٌ وفضيلةٌ، فعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال: “أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ”، ويتأكّدُ صيامُ يومِ عاشوراءَ وهو اليومُ العاشرُ من شهرِ المحرمِ، يومَ نجَّى اللهُ فيه مُوسَى عليهِ السلامُ وقومَهُ مِنْ فرعونَ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صومَهُ على سائرِ الأيامِ، فعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قالَ: “مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ”. أخرجه البخاري، وعَنْ أبي قتادةَ رضي الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: “يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ” ، مبيناً انه يُستحبُّ صيامُ التاسعِ معَهُ، فعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ”. أخرجه مسلم وقالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: “صُومُوا التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ وَخَالِفُوا اليَهُودَ” ، ولو صامَ المسلمُ ثلاثةَ أيامٍ ففي ذلكَ فضلُ صيامِ التاسعِ والعاشرِ، وصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من الشهّرِ، ولو صامَ المسلمُ العاشرَ فقط كفاهُ ذلكَ.
وفي المدينة المنورة تحدّث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا عن فضل الصدق في الأقوال والأعمال, الظاهرة والباطنة, وأثرها على الإنسان في حياته وبعد مماته, وأنها سبب لحلول رضوان الله على عبده, وقبول عمله, ونجاته من عذابه يوم الحساب.
واستهل الشيخ خالد المهنا خطبة الجمعة مبيناً أن ما من عبد امتلأ قلبه من محبة ربه تعالى وتعظيمه وشمول نعمته إلا كانت غايته ونهاية مطلبه حلول رضوان الله عليه, وذلك هو الفضل الكبير الذي هو أكبر من كل نعيم, الذي أنعم به على عباده في جنة الخلد, ومنها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه, فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة, يا أهل الجنة: فيقولون لبيك ربنا وسعديك, فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحداً من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك, فقالوا: يا ربّ وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جلّ جلاله: أحلّ عليكم رضواني فلا أسخطُ عليكم بعده أبداً” أخرجه الإمام البخاري.
وقال الشيخ خالد المهنا: لقد مهّد الكريم سبحانه لعباده سبل حلول رضوانه, وعرّفهم عليها بأدلة الوحي, فقال عزّ سلطانه : “وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ”.
وبيّن أنه مهما كثرت شرائع الدين على المسلم الراغب في مرضاة ربّه فإن لها أساساً تُبنى عليه, ومرجعاً تعود إليه, إذا استمسك به العبد هُدي إلى كل طاعة تبلّغه رضوان مولاه, وذلك الأصل يا عباد الله هو الصدق مع الله, فإنه موجب حلول رضوان الله تعالى على عباده في الدنيا والآخرة, كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في قوله: “عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البِرّ وإن البر يهدي إلى الجنة, وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً” متفق عليه.
وبيّن الشيخ خالد المهنا أن للصدق مع الله تعالى لوازم تنشأ عنه, وبراهين تدل عليه, وثمار طيبة تنبت به, ألا وهي الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة التي لا يزال العبد يتقرّب بها إلى مولاه حتى يكون من خير البرية الموعودين بجزيل الثواب, وحسن المآب, ورضى العزيز الوهاب, قال تعالى : ” إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَ?ئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ? رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ? ذَ?لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ “، مبينًا أن الصادقين مع الله يجدون بركة صدقهم ونفعه أحوج ما كانوا إليه, فقال سبحانه “قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ”
وقال فضيلته: وإذا رضي العبد بربه ورضي عنه رضي الله عن عبده, أشهده يشائر الرضا عنه في الدنيا بتهيئة الطاعة له وصرف المعصية والسوء عنه, فالجزاء من جنس العمل, ورضا العبد بربه يقتضي انقياده لشرعه, واستسلامه لحكمه, من غير حرج في نفسه, ورضاه عن ربّه يكون فيما قضاه له من أقدار وإن آلمته, فمن بلغ تلكم المنزلة السامية بلّغه الله أعلى درجات الرضى عنه, فإن رضى الربّ سبحانه درجات يختصّ بها من يشاء من عباده, كما تتفاوت درجاتهم في جنات النعيم.
وأوضح أن العبد الطامع في مرضاة ربه عليُّ الهمّة, صحيح العزم, عجولٌ إلى أوامر مولاه, سابقٌ بالخيرات, أسوته في ذلك صفوة الخلق وسادة البريّات, كما قال موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام “وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى? ” مبيناً أن ربنا جل جلاله شكور يكرم العبد برضاه إذا كان لسانه لهجاً بحمد ربّه وشكره على ما أنعم به عليه, إذ قال عليه الصلاة والسلام: ” إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها, ويشرب الشربة فيحمده عليها” أخرجه الإمام مسلم
وبيّن أن هذا الجزاء العظيم من الكريم سبحانه هو غاية الفضل, إذ أنعم على عبده بالطعام ثم أساغه له, ثم ألهمه الثناء عليه به, ثم أحلّ عليه رضاه, وربنا سبحانه حليم يعيذ عبده من سخطه برضاه, إذ هو سأله كما كان يسأل المتقين وقدوة السالكين.
واختتم فضيلته الخطبة, مبيناً أن إرضاء الوالدين ببرهما وطاعتهما في غير معصية الله سبب متين لحلول رضوان الله تعالى, وقال عليه الصلاة والسلام: “رضا الله في رضا الوالد, وسخطه في سخط الوالد” أخرجه الترمذي .
أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، المسلمين بتقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه وتجنب مساخطه ومناهيه .
وقال فضيلته: “تتعاقَب الأيامُ، وتتوالى الشّهورُ، وتمضي السُّنون، والأعمارُ تُطوَى، والآجالُ تُقضى، والأبدانُ تَبلَى، وكلُّ شيءٍ بأجلٍ مسمَّى، وها نحنُ قدْ ودعنَا عاماً تقضَّتْ ساعاتُهُ سِراعاً، ومضتْ أوقاتُهُ تِباعاً، وكأنَّها طيفُ خيالٍ، أو ضيفٌ زارَ ثمَّ زالَ، وفي استقبالِ عامٍ وتوديعِ آخَرَ تذكرةٌ للمتدبِّرين وعبرةٌ للمتفكرين، قال تعالى {يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ} ، والبصيرُ لا يركنُ إلى الخُدعِ، ولا يغترُ بالطمعِ، ومن أطالَ الأملَ نسِيَ العملَ، وغفلَ عن الأجلِ، والعاقلُ الحَصيفُ هو مَنْ يتَّخِذُ مِنْ صفَحاتِ الدَّهرِ وانطوائِهِ وقفاتٍ للمحاسبةِ الجادَّةِ، ولحظاتٍ للمُراجعةِ الصّادقةِ، فيرتقي في مراتبِ الكمالِ البشـري الذي أمرَهُ اللهُ بنشدانِهِ، وشَحَذَ الهِمَمَ للسعيّ في بنائِهِ وإتقانِهِ” .
وأشار الدكتور الدوسري إلى أن كلِّ مُكلَّفٍ عَاقِلٍ، وحَتمٌ على كلِّ مُوقنٍ حَازمٍ، وأن يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ لا يغفلَ عنْ مُحاسبةِ نفسِهِ، ومُراجعةِ وتقييمِ مَسارِهِ في ماضِيهِ وحَاضرِهِ ومُستقبلِهِ .
وقال: ” في حوادثِ الأيامِ عِبَرٌ، وفي قوارعِ الدهرِ مُزدَجَرٌ، فالفُرَصُ تَفوتُ، والأجلُ مَوقوتُ، والإقامةُ محدودَةٌ، والأيّامُ معدودةٌ، موضحاً أنَّ هلاكَ القلبِ وأضرَّ ما يكونُ على الإنسانِ: الإهمالُ وتركُ المحاسبةِ، والاسترسالُ وموافقةُ النفسِ واتباعُ هواهَا، فإنَّ هذا يؤولُ بهِ إلى الهلاكِ، وهذه حالُ أهلِ الغرورِ، يُغمضُ عينيهِ عنِ العواقبِ ويتكلُ على العفو، فإذا فعلَ ذلك سهلَ عليهِ مُواقعةُ الذنوبِ وأَنِسَ بها، وعَسرَ عليه فِطامُها، وأنَّ النفسَ خُلقتْ أمارةً بالسوءِ تجري بطبعِهَا في ميدانِ المخالفةِ، وقدْ أُمِرَ العبدُ بتقويمِهَا وتزكيتِهَا، وأنْ يقودَهَا بسلاسلِ القهرِ إلى عبادةِ ربِّهَا، فإنْ أهملَهَا وأغفلَهَا جمحَتْ وشردَتْ وتمردَّتْ، ولم يظفرْ بهَا بعدَ ذلك، وإن قوّمَهَا وحاسبَهَا ارتدعَتْ وأذعنَتْ واستقامَتْ”.
وأضاف فضيلته : “وإذا عَرَفَ الإنسانُ عيوبَ نفسِهِ وآفاتِهَا دفعَهُ ذلك إلى مَقتِهَا، والتذللِ والخضوعِ بينَ يَدي خالقِهَا، كما يدعوهُ ذلكَ إلى محاسبةِ نفسِهِ ومجاهدتِهَا، وتطهيرِهَا مِنَ الذنوبِ، وتنقيتِهَا مِنَ العيوبِ، وتزكيتِهَا طاعةً لعلّامِ الغيوبِ، راجياً بذلك الفوزَ والفلاحَ” .
وذكر إمام وخطيب المسجد الحرام أن السلف الصلح – رحمهم اللهُ – أدركَ هذه المعاني، وقدروهَا حقَّ قدرِهَا، فترجموهَا في حياتِهِم قولاً وعملاً، مبيناً أن التاريخُ سطَّرَ لهمْ أروعَ الوصايا وأعظمَها في هذا الميدانِ، واستفاضتْ مقولاتُهُم وسارتْ بهَا الركبانُ، ومِنْ ذلك الأثرُ الشهيرُ عنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه حينَ قالَ: ( حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ).
وأوضح فضيلة الدكتور الدوسري أنَّ محاسبةَ النفسِ كما تكونُ بعدَ العملِ فإنَّها تكونُ قبلَهُ وفي أثنائِهِ، فأمَّا محاسبتُهَا قبلَ العملِ فيكونُ بالوقوفِ عندَ أولِ همِّهِ وإرادتِهِ، ولا يُبادرُ بالعملِ حتى يتبينَ لهُ رجحانُ العملِ بهِ على تركِهِ، قالَ الحسنُ: ( رَحِمَ اللهُ عبداً وقفَ عندَ همِّهِ، فإنْ كانَ للهِ مَضَى، وإنْ كانَ لغيرِهِ تأخَرَ)، وأما محاسبةُ النَّفسِ في أثنائِهِ فتكونُ بالاجتهادِ في تحقيقِ الإخلاصِ والمتابعةِ في العملِ حتى يفرَغَ منهُ ، وأما محاسبتُهَا بعدَ العملِ فتكونُ بالنظرِ في الفرائضِ والأوامرِ، فإنْ رأى فيهَا نقصاً بذلَ جهدَهُ، واستعانَ بربِهِ في تتميمِهِ وتكميلِهِ، وإتقانِهِ، ثم ينظرُ في المناهِي، فإنْ عَرَفَ أنَّهُ ارتكبَ منهَا شيئاً تداركَهُ بالإقلاعِ والتوبةِ النصوحِ والاستغفارِ والحسناتِ الماحيةِ، والإعراضِ عنِ الأسبابِ الموصلةِ إليه.
وأبان فضيلته أن شهرَ اللهِ المحرمِ شهرٌ رفيعُ القَدْرِ، عظيمُ الأجرِ، والصومُ فيه عبادةٌ جليلةٌ، والإكثارُ منه قربةٌ وفضيلةٌ، فعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال: “أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ”، ويتأكّدُ صيامُ يومِ عاشوراءَ وهو اليومُ العاشرُ من شهرِ المحرمِ، يومَ نجَّى اللهُ فيه مُوسَى عليهِ السلامُ وقومَهُ مِنْ فرعونَ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صومَهُ على سائرِ الأيامِ، فعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قالَ: “مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ”. أخرجه البخاري، وعَنْ أبي قتادةَ رضي الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: “يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ” ، مبيناً انه يُستحبُّ صيامُ التاسعِ معَهُ، فعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ”. أخرجه مسلم وقالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: “صُومُوا التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ وَخَالِفُوا اليَهُودَ” ، ولو صامَ المسلمُ ثلاثةَ أيامٍ ففي ذلكَ فضلُ صيامِ التاسعِ والعاشرِ، وصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من الشهّرِ، ولو صامَ المسلمُ العاشرَ فقط كفاهُ ذلكَ.
وفي المدينة المنورة تحدّث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا عن فضل الصدق في الأقوال والأعمال, الظاهرة والباطنة, وأثرها على الإنسان في حياته وبعد مماته, وأنها سبب لحلول رضوان الله على عبده, وقبول عمله, ونجاته من عذابه يوم الحساب.
واستهل الشيخ خالد المهنا خطبة الجمعة مبيناً أن ما من عبد امتلأ قلبه من محبة ربه تعالى وتعظيمه وشمول نعمته إلا كانت غايته ونهاية مطلبه حلول رضوان الله عليه, وذلك هو الفضل الكبير الذي هو أكبر من كل نعيم, الذي أنعم به على عباده في جنة الخلد, ومنها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه, فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة, يا أهل الجنة: فيقولون لبيك ربنا وسعديك, فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحداً من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك, فقالوا: يا ربّ وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جلّ جلاله: أحلّ عليكم رضواني فلا أسخطُ عليكم بعده أبداً” أخرجه الإمام البخاري.
وقال الشيخ خالد المهنا: لقد مهّد الكريم سبحانه لعباده سبل حلول رضوانه, وعرّفهم عليها بأدلة الوحي, فقال عزّ سلطانه : “وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ”.
وبيّن أنه مهما كثرت شرائع الدين على المسلم الراغب في مرضاة ربّه فإن لها أساساً تُبنى عليه, ومرجعاً تعود إليه, إذا استمسك به العبد هُدي إلى كل طاعة تبلّغه رضوان مولاه, وذلك الأصل يا عباد الله هو الصدق مع الله, فإنه موجب حلول رضوان الله تعالى على عباده في الدنيا والآخرة, كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في قوله: “عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البِرّ وإن البر يهدي إلى الجنة, وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً” متفق عليه.
وبيّن الشيخ خالد المهنا أن للصدق مع الله تعالى لوازم تنشأ عنه, وبراهين تدل عليه, وثمار طيبة تنبت به, ألا وهي الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة التي لا يزال العبد يتقرّب بها إلى مولاه حتى يكون من خير البرية الموعودين بجزيل الثواب, وحسن المآب, ورضى العزيز الوهاب, قال تعالى : ” إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَ?ئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ? رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ? ذَ?لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ “، مبينًا أن الصادقين مع الله يجدون بركة صدقهم ونفعه أحوج ما كانوا إليه, فقال سبحانه “قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ”
وقال فضيلته: وإذا رضي العبد بربه ورضي عنه رضي الله عن عبده, أشهده يشائر الرضا عنه في الدنيا بتهيئة الطاعة له وصرف المعصية والسوء عنه, فالجزاء من جنس العمل, ورضا العبد بربه يقتضي انقياده لشرعه, واستسلامه لحكمه, من غير حرج في نفسه, ورضاه عن ربّه يكون فيما قضاه له من أقدار وإن آلمته, فمن بلغ تلكم المنزلة السامية بلّغه الله أعلى درجات الرضى عنه, فإن رضى الربّ سبحانه درجات يختصّ بها من يشاء من عباده, كما تتفاوت درجاتهم في جنات النعيم.
وأوضح أن العبد الطامع في مرضاة ربه عليُّ الهمّة, صحيح العزم, عجولٌ إلى أوامر مولاه, سابقٌ بالخيرات, أسوته في ذلك صفوة الخلق وسادة البريّات, كما قال موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام “وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى? ” مبيناً أن ربنا جل جلاله شكور يكرم العبد برضاه إذا كان لسانه لهجاً بحمد ربّه وشكره على ما أنعم به عليه, إذ قال عليه الصلاة والسلام: ” إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها, ويشرب الشربة فيحمده عليها” أخرجه الإمام مسلم
وبيّن أن هذا الجزاء العظيم من الكريم سبحانه هو غاية الفضل, إذ أنعم على عبده بالطعام ثم أساغه له, ثم ألهمه الثناء عليه به, ثم أحلّ عليه رضاه, وربنا سبحانه حليم يعيذ عبده من سخطه برضاه, إذ هو سأله كما كان يسأل المتقين وقدوة السالكين.
واختتم فضيلته الخطبة, مبيناً أن إرضاء الوالدين ببرهما وطاعتهما في غير معصية الله سبب متين لحلول رضوان الله تعالى, وقال عليه الصلاة والسلام: “رضا الله في رضا الوالد, وسخطه في سخط الوالد” أخرجه الترمذي