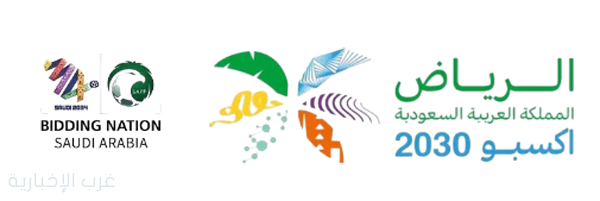* من ورقة مقدَّمة للمؤتمر الدولي الثالث لكلِّية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط: التاريخ بين التصحيح والتحريف. من 6 - 7 / 2 / 1440هـ الموافق لـ 15 - 16 أكتوبر 2018م


المصدر -
منذ أنْ اهتمَّ علماء الغرب بطلب علوم الشرق عموماً، وعلوم العرب والمسلمين خصوصاً، والإسهامات تترى في دراسة الشرق في ماضيه وحاضره، بروح قد تختلف عن الروح التي سادت الشرق، روح الانتماء. فقد انطلقت الدراسات الغربية عن الشرق ببواعث ومنطلقات مختلفة في نظرتها للشرق، بين دينية واحتلالية وسياسية واقتصادية وعلمية. وكلُّ غرض من هذه الأغراض الرئيسة ألقى بظلاله على طبيعة الدراسات ومنهجيتها وأهدافها.
وقد أشبع نقَّاد الاستشراق من العرب والمسلمين هذه الأغراض وأهدافها بالدراسات، التي أخذت في معظمها البُعد الدفاعي، الذي يتوخَّى الردَّ على الطعون والافتراءات والشبهات، وأحياناً بلغة متحاملة يحدوها الانتصار العاطفي للدين وأحكامه وكتابه القرآن الكريم ونبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم ورموزه، غيرةً على الدين والتراث واللغة والثقافة والآداب والعلوم والفنون المؤصَّلة.
وربَّما جاءت معظم هذه الدراسات الغيورة الناقدة للاستشراق والمستشرقين بصيغة التعميم في الأحكام على هذه الظاهرة. بينما الساحة الاستشراقية لا تخلو من وقفات منصفة للتاريخ الإسلامي، يجدها المتابع في ثنايا بعض الدراسات، حتَّى في تلك الدراسات نفسها التي لم تخلُ كذلك من قدرٍ عالٍ من التحامُل على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام. وعليه فإنَّ هذا الباحث يفضِّل دائماً التعبير بالتبعيض، تقديراً لتلك الفئة المنصفة من المستشرقين.
الجناية على التاريخ
ومن خلال استقراء يسير للدراسات الاستشراقية يكاد الباحث يخرج بحكم جازم أنَّ معظم هذه الدراسات الاستشراقية -وليس كلها- غلَّبت جانب الجناية على الإسلام والعروبة، انطلاقاً من العصر الجاهلي الذي سبق الإسلام ببيانه وآدابه وعاداته وتقاليده الحميدة، التي أقرَّها الإسلامُ وحثَّ عليها، ونبذ ما كان منها لا يتواءم مع الأبعاد الإنسانية للحياة.
ومع هذا تتغافل بعض الدراسات الاستشراقية هذه الأبعاد الإنسانية لدى العرب قبل الإسلام، مع أنها تتوافق في أصولها مع التعاليم التي ينطلق الدارسون الغربيون من خلفيتها ابتداءً، سواء أكانوا يهوداً أم نصارى، لا سيَّما بعد ظهور الإسلام المكمِّل للأديان التي سبقته، والمقرِّ للمشتركات التي جاء بها الرسل -عليهم السلام- قبل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، التي جاء بها الوحي المنزَّل على رسل الله -عليهم الصلاة والسلام-.
ولم يختلف الإسلام عن تلك المشتركات إلا بما له علاقة مباشرة بتفصيلات صفات العبادات، التي هي بدورها لم تخلُ من مشترك -في الكيفية حتَّى- مع الأصول في تلك الأديان، مما يقوِّي إمكانية (كسب) الآخرين للإسلام بالحوار والإقناع الذي يُسهم فيه الاستشراق افتراضاً ولا يصدُّ عنه، وليس العكس بجذب المسلمين إلى النصرانية التي غلَّبت الروح على العقل والمادَّة، ثمَّ بادِّعاء أنَّ العقل الغربي بعد ذلك أكثر قدرةً على الإقناع والحوار من العقل الشرقي.
تلك المشتركات الجاذبة كانت قبل أنْ تتدخَّل رغبات الإنسان وميوله في الكتب المنزَّلة على الأنبياء والرسل السابقين، والمبالغة في إعمال عقله على الأحكام والتعاليم، وربَّما تعطيل عقله أحياناً، ومن ثمَّ إصدار أحكامه المحدودة بزمانها ومكانها أخذاً وتطبيقاً، فتُغيِّر من مسلك تلك الأحكام والتعاليم وتطوِّعها إلى أهواء بني الإنسان، مما يجعل هذا النهج في التنازُلات والتكييف للدين وأحكامه لدى الغربيين متواصلاً جيلاً بعد جيل، فيُسهم في الاستمرار في طمس الأصول، ويُبقي على الموروث الكهنوتي المطوَّع للمكان والزمان، مما أثَّر في الاتِّباع مع ضعف الاقتناع.
الأمر الذي لا يحصل للإسلام من قِبَل أتباعه أو ناقديه من المستشرقين أو ممَّن تأثَّر بطرحهم من قريب أو بعيد، لأنَّ هذا الدين محفوظ بوعد الله تعالى بحفظه، لا تطمسه محاولات تشويهه بالشُّبه والافتراءات، التي كان -وما يزال- لبعض المستشرقين أثرٌ واضح فيها.
يستدعي هذا الموقف البحث في أسباب هذا الطرح الاستشراقي السلبي تجاه هذا الدين الإسلامي وأتباعه وتاريخه المتعاقب بأحداثه المتلاحقة. وهذا موضوع يطول الخوض فيه، كما أنَّ الساحة العلمية العربية لا تفتقر إلى تغطية هذا المجال تغطيةً جيِّدةً، لا يحسن معها التكرار.
الاستشراق والتاريخ
والذي لا بُدَّ من التنويه عليه هنا هو أنَّ الدراسات الاستشراقية حول تاريخ العرب والمسلمين لم تكُن حبيسة الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، بل إنها بصفتها منهجاً لدراسة الشرق الإسلامي وحضارته كان لها -وما يزال- (أثرُ كبير على صورة الإسلام والعرب في أوروبَّا، حتَّى بات على الحكومات الأوروبِّية أنْ تأخذ بعين الاعتبار فرضيَّات الاستشراق وأحكامه في تعاملها مع البلدان الشرقية). ومن ثمَّ جاء توظيف هذه الفرضيات الخاطئة والأفكار المنمَّطة أسلوباً (لتكريس العواطف العدائية ضدَّ المسلمين في الحقبة التي شهدت ظهور الدولة العثمانية، وتوسُّعها المبكِّر).
وما يزال هذا الموقف قائماً مع تنامي الخوف من الإسلام، بالنظر إلى كونه خطراً يهدِّد المنجزات الحضارية التي أحرزها الإنسان العائش في المحور أو المركز للعالم وهو الغرب، في مقابل التهديد القادم من الأطراف وهو الشرق والجنوب، دون الالتفات إلى أنَّ هذا الإنسان العائش في المركز قد قَدِم في الغالب من الأطراف، وأنَّ حضارة هذا اليوم، وإن تركَّزت في الغرب من العالم في زمن مضى، إلا أنها لم تكن مقصورةً على جنس بعينه متفوِّق على بقيَّة الأجناس -كما هو زعم بعض المستشرقين وعلماء الأنثروبولوجيا الغربيين-.
والواضح أنَّ من أسباب هذا الموقف الاستشراقي -من جانبٍ آخر من التاريخ الإسلامي بشموله- إقحام الجانب العنصري (الإثني)، والسعي إلى إقرار مفهوم التأثير اليهودي والنصراني من منطلق عرقي في هذا التاريخ وثقافته مباشرةً، بحيث يكون تراثُ المسلمين وتاريخُهم عالةً على اليهودية والنصرانية.
ومن ثمَّ برزت فكرة أنَّ المسلمين في مقوِّمات حضارتهم عالةٌ على الغرب، بعد أنْ استقرَّت غالبية المرجعيات اليهودية والنصرانية في الغرب، من حيث التأثير على الديانتين على الأقلِّ، وإلا يبقى للشرق تأثيره المباشر على هاتين الديانتين السماويتين، ويبقى شعور الغرب بأصالة الشرق في هذا الشأن متجذِّراً في النفوس.
إلا أنه يمكن التركيز على نظرة الاستشراق القديم والمعاصر للتاريخ العربي الإسلامي، وتحديد موقف أغلب المستشرقين تجاهه، انطلاقاً من النظرة إلى المجتمع العربي قبل الإسلام ووصولاً إلى التاريخ الحديث والمعاصر.
والواضح أنَّ التاريخ العربي الإسلامي الحديث والمعاصر يتَّكئ في مقوِّماته على التاريخ العربي القديم، مروراً بالعهود الإسلامية المتعاقبة، تلك التي حفلت بمشروع إعادة الإنسان إلى تقوية علاقته بالخالق -سبحانه وتعالى- في أمور دنياه ودينه، من منطلق عمارة الأرض والاستخلاف عليها.
تسجيل التاريخ
ولا بُدَّ من التوكيد على أنه يحقُّ لكلِّ أمَّةٍ أنْ تسجِّل تاريخها بنفسها وبمنطلقاتها وانتمائها واعتقادها، وبأصالتها وذاتيتها وبمصادرها المعتبرة، مع توخِّي الموضوعية والتجرُّد في سرد التاريخ وتفسيره، ولو جاء على حساب ما يهواه المؤرِّخ. والبُعد عن الموضوعية في توثيق التاريخ جناية على التاريخ نفسه، وعلى الأمَّة التي يُكتب لها التاريخ.
ولا يُكتب تاريخ الأمم إلا بأقلام علمائها ومؤرِّخيها، دون النزوع إلى الانتصار العاطفي والمبالغة في التبجيل وتدخُّل الهوى. فالعاطفة والتبجيل والهوى لم تكن من مصادر التاريخ والتوثيق، كما أنها لا يُمكنْ أنْ تكون من مقوِّمات الدين، أيّ دين ولا الثقافة، أيّ ثقافة.
وأكرِّر في هذا المقام دائماً مقولة الإمام الحافظ عبدالرحمن بن مهدي (135 - 198هـ)، وهو من كبار أئمَّة الحديث الثقات، وغيره قد قال بمثل قوله، مؤكِّدين على توخِّي الموضوعية والتجرُّد عند الكتابة، إذ يقول: (أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم. وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم). وهذه عبارة حاسمةٌ في الكتابة والتوثيق، تغني عن المزيد من الشروح والتعليقات.
والتطفُّل على أهل التاريخ وعلمائه ومفكِّريه ومفسِّريه من قِبَل هذا الباحث وغيره من غير المتخصِّصين لا يحسُن. ولا بُدَّ من احترام التخصُّص، وإن كنت أحبُّ المؤرِّخين ولست منهم. ولذا فإن النقاش هنا يصبُّ في حافة الاستشراق في موقفه من التاريخ العربي الإسلامي، لا في حافة التاريخ نفسه وتصحيحه أو إعادة كتابته، كما هي الدعوات المتكرِّرة والنقاش المستمرِّ بين بعض المؤرِّخين والمتخصِّصين المعتبرين في علم التاريخ وتفسيره. لا من أولئك المتسلِّقين على التاريخ وعلمائه، من الجريئين على التهوين من العلوم والعلماء، بما فيها علم التاريخ الذي له مقامه ومناهجه بين العلوم.
والدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ وتصحيحه وتنقيته هي على أيِّ حالٍ دعواتٌ لها وعليها. يقول المؤرِّخ العربي سهيل زكَّار: (إنَّ التاريخ العربي لم يُكتب بعدُ بشكل عامٍّ أو خاصٍّ، على نحو كامل وبحسب قواعد نقدية علمية، حتَّى تُعاد كتابته وبالتالي تفسيره وتعليله، وترجيح ما هو مهمٌّ فيه وما هو غير مهمٍّ). على ما يكتنف هذا المنهج من مزالق فكرية، قد ترغب في تجاهُل حقائق تاريخية ثابتة، عندما تُحكَّم مناهج بعيدة عن المنهج التاريخي، فقط لأنها قد لا توافق هوىً في النفس، أو توجُّهاً حزبياً أو ثقافيّاً معاصراً، على رأي الإمام عبدالرحمن بن مهدي -رحمه الله-، مما قد يدخل في مفهوم تزييف التاريخ والعبث بالحقائق.
وقد تفاوتت تسجيلات المستشرقين في التاريخ العربي الإسلامي بين الإنصاف والإجحاف. ففي الساحة الاستشراقية مستشرقون منصفون للتاريخ العربي الإسلامي، وإنْ لاقوا بسبب موضوعيتهم وإعجابهم وإنصافهم عنتاً من الفئة الثالثة الأخرى.
وفي الساحة الاستشراقية مستشرقون مجحفون دون قصد منهم، ولكنهم ضعيفون علميّاً، وليس لديهم التمكُّن من عناصر البحث العلمي الموضوعي، ويفتقرون إلى الانتماء لهذا التاريخ وثقافته، أو لديهم ضعفٌ في الحصيلة اللغوية العربية التي تمكِّن المستشرق من الرجوع للمصادر المعتبرة، رغم أن غالبها كان موجوداً بينهم في المكتبات والمتاحف، أو أنهم شديدو الاتِّكاء على مراجع استشراقية سابقة مجحفة، لم تكن تُكنُّ لهذا التاريخ نظرة منصفة.
وقد تتمثَّل هذه العناصر الأربعة مجتمعةً في مستشرق واحد أو أكثر، أو قد يتحقَّق منها ثلاثة عناصر أو عنصران في مستشرق واحد. وأقلُّها أن يتوافَّر عنصر واحد من العناصر الأربعة في المستشرق من هذه الفئة المجحفة دون قصد منها.
ثمَّ تأتي الفئة الثالثة من المستشرقين المجحفين قصداً، بما يحملونه من مكنونات عدائية للتاريخ العربي الإسلامي، وللإسلام نفسه وللمسلمين أنفسهم، مما يدخل في مفهوم تصنيف المستشرقين، من حيث مواقفهم من الدين الذي يكتبون عنه ويؤرِّخون له. وربَّما كانت هذه الفئة الثالثة الأخرى هي التي أساءت إلى مفهوم الاستشراق، وأوجدت في نفوس العلماء والمفكِّرين العرب والمسلمين هواجسَ مسوَّغةً تجاه هذه الظاهرة بين دارسي الإسلام وتراث المسلمين.
اهتمامات المستشرقين
والاقتصار على نظرات بعض المستشرقين للتاريخ يشمل المواقف الاستشراقية الانتقائية من كلِّ ما له صلة بالعروبة والإسلام من الزاوية التاريخية والبنائية للمجتمع المسلم، في عصوره الأولى التي حفلت بالإنجازات على مختلف الأصعدة، فعمد بعضهم إلى تضخيم مواقف تاريخية تسيء للإسلام والمسلمين، كالخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- مثلاً، وحركة الصعاليك وبعض الفرق الخارجة عن الصف فتزندقت أو ثارت على الخلافات المتعاقبة. وعمد آخرون إلى التقليل من مواقف كبرى كانت فيها شهادات للإسلام والمسلمين، كمقاصد الفتوح وسماحة الخلفاء والأمراء والولاة.
ولم يكن هذا النهج مقصوراً على مجال التاريخ فقط، بل شمل فنوناً أخرى كالأدب والمجتمع والتكليفات الشرعية. وتابعهم فيه متأثرين بهم قومٌ من علماء الأمَّة وكتَّابها.
ومن ثمَّ فإن الموقف من القرآن الكريم قد يدخل في جانبٍ منه هذا الطرح، لا من حيث كونه وحيّاً منزَّلاً على رسول الله فحسب، بل من حيث مسيرة هذا الوحي أيضاً بين أيدي المسلمين وفي صدورهم وعنايتهم به حفظاً وتمثُّلاً.
ويشمل هذا الاهتمام بالقرآن الكريم القول بأنه كتابٌ ألَّفه القائد العربي محمد بن عبدالله، وأعانه عليه قومٌ آخرون. هذا مع من لم يؤمنوا بأن القرآن الكريم وحيٌ من الله تعالى، من مثل المستشرق الإنجليزي جورج سيل (1697 - 1736م) الذي أكَّد في مقدِّمته لترجمة معاني القرآن الكريم على أن الشكَّ لا يرقى لكون محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤلِّف القرآن الكريم، بعد أنْ جمع مادَّته من الثقافات المعاصرة له والسابقة عليه، وأعانه على تأليفه قومٌ آخرون! وكأنه لم يمرّْ على الآية الكريمة (103) من سورة النحل: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ).
ثمَّ جاءت كثير من الترجمات التالية لمعاني القرآن الكريم للغات أوروبِّية أخرى عالةً على هذه الترجمة بمقدِّمتها. ومع هذا الافتراء في تغييب الوحي عن القرآن الكريم تظهر على هذا المستشرق المترجم بعض المواقف التي توصف بالإنصاف، فقد ذكر الباحث الضليع عبدالرحمن بدوي أنه قد أنصف الإسلام، وأنه كان (بريئاً -رغم تديُّنه المسيحي- من تعصُّب المبشرين المسيحيين)، إلى درجة أنْ يُطلق عليه (نصف مسلم).
وتعرَّض آخرون ممن لم ينكروا صراحةً أنَّ القرآن الكريم وحيٌ منزَّل من الله تعالى إلى تاريخ نزول الوحي على رسول الله، وجمع القرآن الكريم في مصحف واحد، بعد تجميعه من الصحابة والصحابيات -رضي الله عنهم وعنهن جميعاً- في عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر الصدِّيق وعثمان بن عفَّان -رضي الله عنهما- والبحث في القراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وترتيب السور، وغيرها من علوم القرآن الكريم.
وكان لا بُدَّ من تفنيد هذه الافتراءات المتتالية، غيرةً على كتاب الله تعالى، وذلك في أعمال تتوالى بأقلام الباحثين والباحثات المسلمين والمسلمات، ثمَّ مؤخَّراً بأقلام بعض المستشرقين والمستشرقات.
ويسعى هذا الباحث إلى رصد ما كتبه نقَّاد الاستشراق من العرب والمسلمين، بل وبعض المستشرقين أنفسهم لما أسهم به المستشرقون من دراسات وترجمات لمعاني القرآن الكريم في التفريعات المذكورة أعلاه. وما يزال مشروع الرصد الوراقي (الببليوجرافي) مستمرّاً بعون الله تعالى، شاملاً لما نُشر في المراجع العربية لكلِّ ما له علاقة بالإسلام والمسلمين.
ويشمل النظر في تاريخ شخصية الرسول محمد وحياته الخاصَّة وسيرته -عليه الصلاة والسلام-، والرسالة نفسها وتدوين السنَّة النبوية، وما اعترى هذا المشروع من تشكيكات المستشرقين ومَن تأثَّر بطرحهم في آليات جمع الحديث وتدوينه، والدقَّة المتناهية في معرفة الرجال وتتبُّع أحوالهم قبل الأخذ عنهم. على أنَّ التشكيك في رواة الحديث (السند) قد يُراد منه الوصول إلى التشكيك في الحديث نفسه (المتن).
الفتوحات الإسلامية
ثمَّ يمرُّ النقاش على نظرة المستشرقين لفتوح المسلمين وغزواتهم من حيث أهدافها وغاياتها، بتحريف مقاصد هذه الفتوح والغزوات، وإسباغ مفهومات الاحتلال (الاستعمار) والجانب الاقتصادي والمادِّي والسلطوي والتوسُّع الهيمني عليها، قياساً بالأطماع السارية اليوم، مما يدخل في مفهوم الإسقاط، التي أوصلها الباحث شوقي أبو خليل -رحمه الله- إلى عشرين إسقاطاً. يقول الباحث فاروق عمر فوزي: (لقد أخطأ بعض المستشرقين حين نظروا إلى تاريخ صدر الإسلام بمنظار القرن العشرين والتفاسير السائدة فيه).
ومن ثمَّ السعي إلى استبعاد الجانب الدعوي، المقصود لذاته بنشر الإسلام طوعاً لا كرهاً، وقصر هذه الجهود الجهادية على الغنيمة والتخريب، كما هو رأي المستشرق الألماني كارل بروكلمان (1868 - 1956م) في كتابه المشهور (تاريخ الشعوب الإسلامية).
ويُنقل عن المستشرق الفرنسي كازانوفا قوله: (كانت نفسية الأُمويين عموماً نفسيةً مجبولةً على الطمع ومحاولة الإثراء إلى حدِّ الجشع وحبّ الفتح من أجل النهب والحرص على التسوُّد للتمتُّع بالملذَّات الدنيوية).
بالإضافة إلى (حزمة) من التأويلات المادِّية التي تُخرج مقاصد تلك الفتوحات عن غاياتها السامية. وقد تتبَّع شوقي أبو خليل -رحمه الله- عدداً من الهنات التي وقع بها بروكلمان في كتابه (تاريخ الشعوب الإسلامية). كما تتبَّعه غيره من الباحثين بالنقد والتفنيد. ويحتاج هذا الكتاب تحديداً المزيد من النقد الموضوعي، والوقوف على الافتراءات التي جاء بها عمدة من أعمدة الاستشراق.
ويمكن كذلك استعراض روايات تاريخ الإسلام لجرجي زيدان، التي نحت نحو الأسباب المادِّية الدنيوية في الفتوح. ولم يسلم من هذا قادة الفتوح، حيث يقحم جورجي زيدان البُعد العاطفي في دوافع الفتوح.
ويلمز بعض المستشرقين الذين كتبوا عن تاريخ المسلمين بعض القادة الفاتحين بأنهم قُساة طغاة، ربَّما سيَّرهم المال أو الجنس، وأنهم لا يقيمون للعبادة ولا لدورها وزناً. ولذلك يتَّهمون هؤلاء القادة بالإساءة إلى دُور العبادة ورجال الدين النسَّاك فيها. وربَّما يعمدون إلى هدمها وتشريد المقيمين فيها.
ولم يسلم القائد المسلم صلاح الدين الأيُّوبي (532 - 589هـ الموافق لـ 1138 - 1193م) من هذا اللمز، حينما اتَّهمه بروكلمان نفسه بهدم دور العبادة في القدس من فلسطين، يقول: (وهدم صلاح الدين جميع أماكن العبادة النصرانية في هذه البقعة المقدَّسة). بينما واقع الحال أنَّ صلاح الدين -رحمه الله- قد أمر بترميم دُور العبادة والعناية بها.
هذا بالإضافة إلى أنَّ بعض المستشرقين يجعل دوافع صلاح الدين الأيُّوبي في الفتوح لما حصل لأخته من مضايقات من الإفرنج! ونقلها عنهم جورجي زيدان في روايته عن القائد المسلم صلاح الدين الأيُّوبي.
كما أنَّ بعض المستشرقين قد يتجاهل في هذا المقام آداب الحرب وأخلاقياته عند المسلمين، تلك التي تنهى عن التعرُّض لكبار السن والنسَّاك ودُور العبادة والنساء والأطفال والبيئة والحيوانات والمعالم، بما فيها القلاع والحصون.
وتتأجَّج المزاعم والافتراءات على التاريخ الإسلامي (الحربي) أو (العسكري) عندما يأتي ذكر حروب الفرنجة، أو الحروب الصليبية القادمة من الغرب (491 - 690هـ الموافق لـ 1098 - 1291م)، تلك التي لم تظفر بالنصر طيلة الحملات الثماني، والتي كانت غالبية ميادينها أرض فلسطين والشام ومصر من ديار الشرق، وليس في الغرب نفسه. فتترى الاتهامات على المسلمين أيضاً في تكوينهم الثقافي، وأنَّ دينهم يعلِّمهم الجمود ويدعوهم إليه، بمجرَّد إيمانهم بفكرة الجبر في الأفعال والأقوال.
هذا الموقف، من عدَّة مواقف أخرى، لا بُدَّ أنْ تكون له أسباب -كما تذكر المستشرقة الألمانية زيجريد هونكه (1913 - 1999م)- تجعل (الأحكام المسبقة (عن الإسلام والمسلمين) التي سادت القرون الوسطى، وما زالت مستمرَّةً حتَّى اليوم، هي التي تعوق التعرُّف الموضوعي على عالمهم الروحي، وعلى دينهم وتاريخهم وثقافتهم. ويبدو أنها ما زالت تسيطر حتَّى اليوم على الرأي العامِّ عن العرب، من خلال تزييف التاريخ).
وإذا وقفنا عند إنجازات المجتمعات المسلمة في العصور الأولى في مجالات العلوم التطبيقية والبحتة والاجتماعية والنفسية؛ يظهر بعض المستشرقين منكرين لهذه الإنجازات ولمنجزيها، متجاهلين النهضة العلمية التي شارك فيها علماءُ ذلك الزمان من المسلمين وغير المسلمين، داخل مجتمعٍ كان يعجُّ بالتأليف والاختراعات والإبداعات في جوٍّ من السماحة الدينية، مصحوباً بالتشجيع على هذا من الخلفاء والأمراء والولاة والموسرين، مما هو معروف مبسوط في تاريخ العلوم عند المسلمين.
فيأتي كتاب تاريخ كمبرج للإسلام ويتغافل عن هذه الإنجازات الحضارية. ويسهم المستشرق النمساوي غوستاف فون غرونباوم (1909 - 1972م) في هذا التجاهُل، عندما يسم هذا العصر العلمي بأنه عصر اقتباس وتقليد للحضارات القديمة. حتى الأدب عنده من شعر ونثر كتبه الفرس.
مواقف إيجابية
هذا النوع من التجاهُل حدا ببعض المفكِّرين الغربيين أنفسهم إلى إنصاف المسلمين، وعدم الاستمرار في إنكار جهودهم وتضييع ممارساتهم في نقل الحضارة وصقلها والإضافة إليها، بحيث يُعتمد ما خلَّفوه بعدئذٍ من تراث خالد فيما لحق من مؤسسات علمية وبحثية. وأنه يظلُّ للمسلمين فضلٌ على العالم في الأبعاد الحضارية، النقيَّة من شوائب السحر والشعوذة المتوارثة في بعض الثقافات، بما فيها ثقافات العالم الغربي، كما تقرِّر المستشرقة الألمانية المنصفة زيجريد هونكه (1913 - 1999م).
وزيجرد هونكه المنصفة لتاريخ العرب والمسلمين هي التي تقول: (التاريخ يثبت ويؤكِّد أنَّ العرب بمؤلَّفاتهم العظيمة هم أساتذة أوروبَّا. وهذه الكتب قد استُخدمت قديماً لتخريج أطبَّاء بغداد وقرطبة. وهذه الكتب أيضاً هي التي تخرَّج عليها عددٌ كبيرٌ من الأجيال، سواء في العالم الإسلامي أو المسيحي الأوروبِّي، وبخاصَّةٍ في الطبِّ. فمؤلِّفو هذه الكتب العربية لم يكُن يخطر ببالهم أنَّ كتبهم ستجد هذا الإقبال وذلك الرواج). وهي نفسها صاحبة كتاب (التوجُّه الأوروبِّي إلى العرب والإسلام حقيقة قادمة وقدر محتوم).
هذه المواقف الإيجابية من التاريخ العربي الإسلامي القادمة من المستشرقين ليست وليدة هذا الزمان، كما يوحي به المرجعان أعلاه، بل إنَّ في الساحة الاستشراقية القديمة أعلاماً انبروا لإيضاح الوجه المضيء دائماً لتاريخ الإسلام والمسلمين. فهذا (شهيد التراث العربي) يوهان يعقوب رايسكه (1716 - 1774م) من أعلام الاستشراق الألماني في القرن الثامن عشر الميلادي، يقف وقفاتٍ واضحةً منافحاً عن المسلمين وتاريخهم وتراثهم المخطوط ويصف المخطوطات العربية بأنها أولاده، حيث لم يكن له أولاد.
ويلقى بسبب مواقفه هذه من التراث العربي الإسلامي العنت والهجران والإهمال من أترابه المعاصرين له الذين لا يُريدون الإنصاف ولا يسعون إليه، ومن السلطة القائمة في حينه. وله أتراب قبله وبعده خدموا التراث العربي الإسلامي.
وهذه المواقف الإيجابية تنفي لهجة التحامُل على المستشرقين بعمومهم. ويقتضي النقد الموضوعي الابتعاد عن التعميم في الأحكام، دون الانبهار في الوقت نفسه والتبجيل لإسهامات المستشرقين، وأنهم فهموا التاريخ الإسلامي أفضل من فهم المسلمين له! فالمنهج الوسط حريٌّ بأنْ يضع الأمور في نصابها.
وقد أشبع نقَّاد الاستشراق من العرب والمسلمين هذه الأغراض وأهدافها بالدراسات، التي أخذت في معظمها البُعد الدفاعي، الذي يتوخَّى الردَّ على الطعون والافتراءات والشبهات، وأحياناً بلغة متحاملة يحدوها الانتصار العاطفي للدين وأحكامه وكتابه القرآن الكريم ونبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم ورموزه، غيرةً على الدين والتراث واللغة والثقافة والآداب والعلوم والفنون المؤصَّلة.
وربَّما جاءت معظم هذه الدراسات الغيورة الناقدة للاستشراق والمستشرقين بصيغة التعميم في الأحكام على هذه الظاهرة. بينما الساحة الاستشراقية لا تخلو من وقفات منصفة للتاريخ الإسلامي، يجدها المتابع في ثنايا بعض الدراسات، حتَّى في تلك الدراسات نفسها التي لم تخلُ كذلك من قدرٍ عالٍ من التحامُل على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام. وعليه فإنَّ هذا الباحث يفضِّل دائماً التعبير بالتبعيض، تقديراً لتلك الفئة المنصفة من المستشرقين.
الجناية على التاريخ
ومن خلال استقراء يسير للدراسات الاستشراقية يكاد الباحث يخرج بحكم جازم أنَّ معظم هذه الدراسات الاستشراقية -وليس كلها- غلَّبت جانب الجناية على الإسلام والعروبة، انطلاقاً من العصر الجاهلي الذي سبق الإسلام ببيانه وآدابه وعاداته وتقاليده الحميدة، التي أقرَّها الإسلامُ وحثَّ عليها، ونبذ ما كان منها لا يتواءم مع الأبعاد الإنسانية للحياة.
ومع هذا تتغافل بعض الدراسات الاستشراقية هذه الأبعاد الإنسانية لدى العرب قبل الإسلام، مع أنها تتوافق في أصولها مع التعاليم التي ينطلق الدارسون الغربيون من خلفيتها ابتداءً، سواء أكانوا يهوداً أم نصارى، لا سيَّما بعد ظهور الإسلام المكمِّل للأديان التي سبقته، والمقرِّ للمشتركات التي جاء بها الرسل -عليهم السلام- قبل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، التي جاء بها الوحي المنزَّل على رسل الله -عليهم الصلاة والسلام-.
ولم يختلف الإسلام عن تلك المشتركات إلا بما له علاقة مباشرة بتفصيلات صفات العبادات، التي هي بدورها لم تخلُ من مشترك -في الكيفية حتَّى- مع الأصول في تلك الأديان، مما يقوِّي إمكانية (كسب) الآخرين للإسلام بالحوار والإقناع الذي يُسهم فيه الاستشراق افتراضاً ولا يصدُّ عنه، وليس العكس بجذب المسلمين إلى النصرانية التي غلَّبت الروح على العقل والمادَّة، ثمَّ بادِّعاء أنَّ العقل الغربي بعد ذلك أكثر قدرةً على الإقناع والحوار من العقل الشرقي.
تلك المشتركات الجاذبة كانت قبل أنْ تتدخَّل رغبات الإنسان وميوله في الكتب المنزَّلة على الأنبياء والرسل السابقين، والمبالغة في إعمال عقله على الأحكام والتعاليم، وربَّما تعطيل عقله أحياناً، ومن ثمَّ إصدار أحكامه المحدودة بزمانها ومكانها أخذاً وتطبيقاً، فتُغيِّر من مسلك تلك الأحكام والتعاليم وتطوِّعها إلى أهواء بني الإنسان، مما يجعل هذا النهج في التنازُلات والتكييف للدين وأحكامه لدى الغربيين متواصلاً جيلاً بعد جيل، فيُسهم في الاستمرار في طمس الأصول، ويُبقي على الموروث الكهنوتي المطوَّع للمكان والزمان، مما أثَّر في الاتِّباع مع ضعف الاقتناع.
الأمر الذي لا يحصل للإسلام من قِبَل أتباعه أو ناقديه من المستشرقين أو ممَّن تأثَّر بطرحهم من قريب أو بعيد، لأنَّ هذا الدين محفوظ بوعد الله تعالى بحفظه، لا تطمسه محاولات تشويهه بالشُّبه والافتراءات، التي كان -وما يزال- لبعض المستشرقين أثرٌ واضح فيها.
يستدعي هذا الموقف البحث في أسباب هذا الطرح الاستشراقي السلبي تجاه هذا الدين الإسلامي وأتباعه وتاريخه المتعاقب بأحداثه المتلاحقة. وهذا موضوع يطول الخوض فيه، كما أنَّ الساحة العلمية العربية لا تفتقر إلى تغطية هذا المجال تغطيةً جيِّدةً، لا يحسن معها التكرار.
الاستشراق والتاريخ
والذي لا بُدَّ من التنويه عليه هنا هو أنَّ الدراسات الاستشراقية حول تاريخ العرب والمسلمين لم تكُن حبيسة الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، بل إنها بصفتها منهجاً لدراسة الشرق الإسلامي وحضارته كان لها -وما يزال- (أثرُ كبير على صورة الإسلام والعرب في أوروبَّا، حتَّى بات على الحكومات الأوروبِّية أنْ تأخذ بعين الاعتبار فرضيَّات الاستشراق وأحكامه في تعاملها مع البلدان الشرقية). ومن ثمَّ جاء توظيف هذه الفرضيات الخاطئة والأفكار المنمَّطة أسلوباً (لتكريس العواطف العدائية ضدَّ المسلمين في الحقبة التي شهدت ظهور الدولة العثمانية، وتوسُّعها المبكِّر).
وما يزال هذا الموقف قائماً مع تنامي الخوف من الإسلام، بالنظر إلى كونه خطراً يهدِّد المنجزات الحضارية التي أحرزها الإنسان العائش في المحور أو المركز للعالم وهو الغرب، في مقابل التهديد القادم من الأطراف وهو الشرق والجنوب، دون الالتفات إلى أنَّ هذا الإنسان العائش في المركز قد قَدِم في الغالب من الأطراف، وأنَّ حضارة هذا اليوم، وإن تركَّزت في الغرب من العالم في زمن مضى، إلا أنها لم تكن مقصورةً على جنس بعينه متفوِّق على بقيَّة الأجناس -كما هو زعم بعض المستشرقين وعلماء الأنثروبولوجيا الغربيين-.
والواضح أنَّ من أسباب هذا الموقف الاستشراقي -من جانبٍ آخر من التاريخ الإسلامي بشموله- إقحام الجانب العنصري (الإثني)، والسعي إلى إقرار مفهوم التأثير اليهودي والنصراني من منطلق عرقي في هذا التاريخ وثقافته مباشرةً، بحيث يكون تراثُ المسلمين وتاريخُهم عالةً على اليهودية والنصرانية.
ومن ثمَّ برزت فكرة أنَّ المسلمين في مقوِّمات حضارتهم عالةٌ على الغرب، بعد أنْ استقرَّت غالبية المرجعيات اليهودية والنصرانية في الغرب، من حيث التأثير على الديانتين على الأقلِّ، وإلا يبقى للشرق تأثيره المباشر على هاتين الديانتين السماويتين، ويبقى شعور الغرب بأصالة الشرق في هذا الشأن متجذِّراً في النفوس.
إلا أنه يمكن التركيز على نظرة الاستشراق القديم والمعاصر للتاريخ العربي الإسلامي، وتحديد موقف أغلب المستشرقين تجاهه، انطلاقاً من النظرة إلى المجتمع العربي قبل الإسلام ووصولاً إلى التاريخ الحديث والمعاصر.
والواضح أنَّ التاريخ العربي الإسلامي الحديث والمعاصر يتَّكئ في مقوِّماته على التاريخ العربي القديم، مروراً بالعهود الإسلامية المتعاقبة، تلك التي حفلت بمشروع إعادة الإنسان إلى تقوية علاقته بالخالق -سبحانه وتعالى- في أمور دنياه ودينه، من منطلق عمارة الأرض والاستخلاف عليها.
تسجيل التاريخ
ولا بُدَّ من التوكيد على أنه يحقُّ لكلِّ أمَّةٍ أنْ تسجِّل تاريخها بنفسها وبمنطلقاتها وانتمائها واعتقادها، وبأصالتها وذاتيتها وبمصادرها المعتبرة، مع توخِّي الموضوعية والتجرُّد في سرد التاريخ وتفسيره، ولو جاء على حساب ما يهواه المؤرِّخ. والبُعد عن الموضوعية في توثيق التاريخ جناية على التاريخ نفسه، وعلى الأمَّة التي يُكتب لها التاريخ.
ولا يُكتب تاريخ الأمم إلا بأقلام علمائها ومؤرِّخيها، دون النزوع إلى الانتصار العاطفي والمبالغة في التبجيل وتدخُّل الهوى. فالعاطفة والتبجيل والهوى لم تكن من مصادر التاريخ والتوثيق، كما أنها لا يُمكنْ أنْ تكون من مقوِّمات الدين، أيّ دين ولا الثقافة، أيّ ثقافة.
وأكرِّر في هذا المقام دائماً مقولة الإمام الحافظ عبدالرحمن بن مهدي (135 - 198هـ)، وهو من كبار أئمَّة الحديث الثقات، وغيره قد قال بمثل قوله، مؤكِّدين على توخِّي الموضوعية والتجرُّد عند الكتابة، إذ يقول: (أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم. وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم). وهذه عبارة حاسمةٌ في الكتابة والتوثيق، تغني عن المزيد من الشروح والتعليقات.
والتطفُّل على أهل التاريخ وعلمائه ومفكِّريه ومفسِّريه من قِبَل هذا الباحث وغيره من غير المتخصِّصين لا يحسُن. ولا بُدَّ من احترام التخصُّص، وإن كنت أحبُّ المؤرِّخين ولست منهم. ولذا فإن النقاش هنا يصبُّ في حافة الاستشراق في موقفه من التاريخ العربي الإسلامي، لا في حافة التاريخ نفسه وتصحيحه أو إعادة كتابته، كما هي الدعوات المتكرِّرة والنقاش المستمرِّ بين بعض المؤرِّخين والمتخصِّصين المعتبرين في علم التاريخ وتفسيره. لا من أولئك المتسلِّقين على التاريخ وعلمائه، من الجريئين على التهوين من العلوم والعلماء، بما فيها علم التاريخ الذي له مقامه ومناهجه بين العلوم.
والدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ وتصحيحه وتنقيته هي على أيِّ حالٍ دعواتٌ لها وعليها. يقول المؤرِّخ العربي سهيل زكَّار: (إنَّ التاريخ العربي لم يُكتب بعدُ بشكل عامٍّ أو خاصٍّ، على نحو كامل وبحسب قواعد نقدية علمية، حتَّى تُعاد كتابته وبالتالي تفسيره وتعليله، وترجيح ما هو مهمٌّ فيه وما هو غير مهمٍّ). على ما يكتنف هذا المنهج من مزالق فكرية، قد ترغب في تجاهُل حقائق تاريخية ثابتة، عندما تُحكَّم مناهج بعيدة عن المنهج التاريخي، فقط لأنها قد لا توافق هوىً في النفس، أو توجُّهاً حزبياً أو ثقافيّاً معاصراً، على رأي الإمام عبدالرحمن بن مهدي -رحمه الله-، مما قد يدخل في مفهوم تزييف التاريخ والعبث بالحقائق.
وقد تفاوتت تسجيلات المستشرقين في التاريخ العربي الإسلامي بين الإنصاف والإجحاف. ففي الساحة الاستشراقية مستشرقون منصفون للتاريخ العربي الإسلامي، وإنْ لاقوا بسبب موضوعيتهم وإعجابهم وإنصافهم عنتاً من الفئة الثالثة الأخرى.
وفي الساحة الاستشراقية مستشرقون مجحفون دون قصد منهم، ولكنهم ضعيفون علميّاً، وليس لديهم التمكُّن من عناصر البحث العلمي الموضوعي، ويفتقرون إلى الانتماء لهذا التاريخ وثقافته، أو لديهم ضعفٌ في الحصيلة اللغوية العربية التي تمكِّن المستشرق من الرجوع للمصادر المعتبرة، رغم أن غالبها كان موجوداً بينهم في المكتبات والمتاحف، أو أنهم شديدو الاتِّكاء على مراجع استشراقية سابقة مجحفة، لم تكن تُكنُّ لهذا التاريخ نظرة منصفة.
وقد تتمثَّل هذه العناصر الأربعة مجتمعةً في مستشرق واحد أو أكثر، أو قد يتحقَّق منها ثلاثة عناصر أو عنصران في مستشرق واحد. وأقلُّها أن يتوافَّر عنصر واحد من العناصر الأربعة في المستشرق من هذه الفئة المجحفة دون قصد منها.
ثمَّ تأتي الفئة الثالثة من المستشرقين المجحفين قصداً، بما يحملونه من مكنونات عدائية للتاريخ العربي الإسلامي، وللإسلام نفسه وللمسلمين أنفسهم، مما يدخل في مفهوم تصنيف المستشرقين، من حيث مواقفهم من الدين الذي يكتبون عنه ويؤرِّخون له. وربَّما كانت هذه الفئة الثالثة الأخرى هي التي أساءت إلى مفهوم الاستشراق، وأوجدت في نفوس العلماء والمفكِّرين العرب والمسلمين هواجسَ مسوَّغةً تجاه هذه الظاهرة بين دارسي الإسلام وتراث المسلمين.
اهتمامات المستشرقين
والاقتصار على نظرات بعض المستشرقين للتاريخ يشمل المواقف الاستشراقية الانتقائية من كلِّ ما له صلة بالعروبة والإسلام من الزاوية التاريخية والبنائية للمجتمع المسلم، في عصوره الأولى التي حفلت بالإنجازات على مختلف الأصعدة، فعمد بعضهم إلى تضخيم مواقف تاريخية تسيء للإسلام والمسلمين، كالخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- مثلاً، وحركة الصعاليك وبعض الفرق الخارجة عن الصف فتزندقت أو ثارت على الخلافات المتعاقبة. وعمد آخرون إلى التقليل من مواقف كبرى كانت فيها شهادات للإسلام والمسلمين، كمقاصد الفتوح وسماحة الخلفاء والأمراء والولاة.
ولم يكن هذا النهج مقصوراً على مجال التاريخ فقط، بل شمل فنوناً أخرى كالأدب والمجتمع والتكليفات الشرعية. وتابعهم فيه متأثرين بهم قومٌ من علماء الأمَّة وكتَّابها.
ومن ثمَّ فإن الموقف من القرآن الكريم قد يدخل في جانبٍ منه هذا الطرح، لا من حيث كونه وحيّاً منزَّلاً على رسول الله فحسب، بل من حيث مسيرة هذا الوحي أيضاً بين أيدي المسلمين وفي صدورهم وعنايتهم به حفظاً وتمثُّلاً.
ويشمل هذا الاهتمام بالقرآن الكريم القول بأنه كتابٌ ألَّفه القائد العربي محمد بن عبدالله، وأعانه عليه قومٌ آخرون. هذا مع من لم يؤمنوا بأن القرآن الكريم وحيٌ من الله تعالى، من مثل المستشرق الإنجليزي جورج سيل (1697 - 1736م) الذي أكَّد في مقدِّمته لترجمة معاني القرآن الكريم على أن الشكَّ لا يرقى لكون محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤلِّف القرآن الكريم، بعد أنْ جمع مادَّته من الثقافات المعاصرة له والسابقة عليه، وأعانه على تأليفه قومٌ آخرون! وكأنه لم يمرّْ على الآية الكريمة (103) من سورة النحل: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ).
ثمَّ جاءت كثير من الترجمات التالية لمعاني القرآن الكريم للغات أوروبِّية أخرى عالةً على هذه الترجمة بمقدِّمتها. ومع هذا الافتراء في تغييب الوحي عن القرآن الكريم تظهر على هذا المستشرق المترجم بعض المواقف التي توصف بالإنصاف، فقد ذكر الباحث الضليع عبدالرحمن بدوي أنه قد أنصف الإسلام، وأنه كان (بريئاً -رغم تديُّنه المسيحي- من تعصُّب المبشرين المسيحيين)، إلى درجة أنْ يُطلق عليه (نصف مسلم).
وتعرَّض آخرون ممن لم ينكروا صراحةً أنَّ القرآن الكريم وحيٌ منزَّل من الله تعالى إلى تاريخ نزول الوحي على رسول الله، وجمع القرآن الكريم في مصحف واحد، بعد تجميعه من الصحابة والصحابيات -رضي الله عنهم وعنهن جميعاً- في عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر الصدِّيق وعثمان بن عفَّان -رضي الله عنهما- والبحث في القراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وترتيب السور، وغيرها من علوم القرآن الكريم.
وكان لا بُدَّ من تفنيد هذه الافتراءات المتتالية، غيرةً على كتاب الله تعالى، وذلك في أعمال تتوالى بأقلام الباحثين والباحثات المسلمين والمسلمات، ثمَّ مؤخَّراً بأقلام بعض المستشرقين والمستشرقات.
ويسعى هذا الباحث إلى رصد ما كتبه نقَّاد الاستشراق من العرب والمسلمين، بل وبعض المستشرقين أنفسهم لما أسهم به المستشرقون من دراسات وترجمات لمعاني القرآن الكريم في التفريعات المذكورة أعلاه. وما يزال مشروع الرصد الوراقي (الببليوجرافي) مستمرّاً بعون الله تعالى، شاملاً لما نُشر في المراجع العربية لكلِّ ما له علاقة بالإسلام والمسلمين.
ويشمل النظر في تاريخ شخصية الرسول محمد وحياته الخاصَّة وسيرته -عليه الصلاة والسلام-، والرسالة نفسها وتدوين السنَّة النبوية، وما اعترى هذا المشروع من تشكيكات المستشرقين ومَن تأثَّر بطرحهم في آليات جمع الحديث وتدوينه، والدقَّة المتناهية في معرفة الرجال وتتبُّع أحوالهم قبل الأخذ عنهم. على أنَّ التشكيك في رواة الحديث (السند) قد يُراد منه الوصول إلى التشكيك في الحديث نفسه (المتن).
الفتوحات الإسلامية
ثمَّ يمرُّ النقاش على نظرة المستشرقين لفتوح المسلمين وغزواتهم من حيث أهدافها وغاياتها، بتحريف مقاصد هذه الفتوح والغزوات، وإسباغ مفهومات الاحتلال (الاستعمار) والجانب الاقتصادي والمادِّي والسلطوي والتوسُّع الهيمني عليها، قياساً بالأطماع السارية اليوم، مما يدخل في مفهوم الإسقاط، التي أوصلها الباحث شوقي أبو خليل -رحمه الله- إلى عشرين إسقاطاً. يقول الباحث فاروق عمر فوزي: (لقد أخطأ بعض المستشرقين حين نظروا إلى تاريخ صدر الإسلام بمنظار القرن العشرين والتفاسير السائدة فيه).
ومن ثمَّ السعي إلى استبعاد الجانب الدعوي، المقصود لذاته بنشر الإسلام طوعاً لا كرهاً، وقصر هذه الجهود الجهادية على الغنيمة والتخريب، كما هو رأي المستشرق الألماني كارل بروكلمان (1868 - 1956م) في كتابه المشهور (تاريخ الشعوب الإسلامية).
ويُنقل عن المستشرق الفرنسي كازانوفا قوله: (كانت نفسية الأُمويين عموماً نفسيةً مجبولةً على الطمع ومحاولة الإثراء إلى حدِّ الجشع وحبّ الفتح من أجل النهب والحرص على التسوُّد للتمتُّع بالملذَّات الدنيوية).
بالإضافة إلى (حزمة) من التأويلات المادِّية التي تُخرج مقاصد تلك الفتوحات عن غاياتها السامية. وقد تتبَّع شوقي أبو خليل -رحمه الله- عدداً من الهنات التي وقع بها بروكلمان في كتابه (تاريخ الشعوب الإسلامية). كما تتبَّعه غيره من الباحثين بالنقد والتفنيد. ويحتاج هذا الكتاب تحديداً المزيد من النقد الموضوعي، والوقوف على الافتراءات التي جاء بها عمدة من أعمدة الاستشراق.
ويمكن كذلك استعراض روايات تاريخ الإسلام لجرجي زيدان، التي نحت نحو الأسباب المادِّية الدنيوية في الفتوح. ولم يسلم من هذا قادة الفتوح، حيث يقحم جورجي زيدان البُعد العاطفي في دوافع الفتوح.
ويلمز بعض المستشرقين الذين كتبوا عن تاريخ المسلمين بعض القادة الفاتحين بأنهم قُساة طغاة، ربَّما سيَّرهم المال أو الجنس، وأنهم لا يقيمون للعبادة ولا لدورها وزناً. ولذلك يتَّهمون هؤلاء القادة بالإساءة إلى دُور العبادة ورجال الدين النسَّاك فيها. وربَّما يعمدون إلى هدمها وتشريد المقيمين فيها.
ولم يسلم القائد المسلم صلاح الدين الأيُّوبي (532 - 589هـ الموافق لـ 1138 - 1193م) من هذا اللمز، حينما اتَّهمه بروكلمان نفسه بهدم دور العبادة في القدس من فلسطين، يقول: (وهدم صلاح الدين جميع أماكن العبادة النصرانية في هذه البقعة المقدَّسة). بينما واقع الحال أنَّ صلاح الدين -رحمه الله- قد أمر بترميم دُور العبادة والعناية بها.
هذا بالإضافة إلى أنَّ بعض المستشرقين يجعل دوافع صلاح الدين الأيُّوبي في الفتوح لما حصل لأخته من مضايقات من الإفرنج! ونقلها عنهم جورجي زيدان في روايته عن القائد المسلم صلاح الدين الأيُّوبي.
كما أنَّ بعض المستشرقين قد يتجاهل في هذا المقام آداب الحرب وأخلاقياته عند المسلمين، تلك التي تنهى عن التعرُّض لكبار السن والنسَّاك ودُور العبادة والنساء والأطفال والبيئة والحيوانات والمعالم، بما فيها القلاع والحصون.
وتتأجَّج المزاعم والافتراءات على التاريخ الإسلامي (الحربي) أو (العسكري) عندما يأتي ذكر حروب الفرنجة، أو الحروب الصليبية القادمة من الغرب (491 - 690هـ الموافق لـ 1098 - 1291م)، تلك التي لم تظفر بالنصر طيلة الحملات الثماني، والتي كانت غالبية ميادينها أرض فلسطين والشام ومصر من ديار الشرق، وليس في الغرب نفسه. فتترى الاتهامات على المسلمين أيضاً في تكوينهم الثقافي، وأنَّ دينهم يعلِّمهم الجمود ويدعوهم إليه، بمجرَّد إيمانهم بفكرة الجبر في الأفعال والأقوال.
هذا الموقف، من عدَّة مواقف أخرى، لا بُدَّ أنْ تكون له أسباب -كما تذكر المستشرقة الألمانية زيجريد هونكه (1913 - 1999م)- تجعل (الأحكام المسبقة (عن الإسلام والمسلمين) التي سادت القرون الوسطى، وما زالت مستمرَّةً حتَّى اليوم، هي التي تعوق التعرُّف الموضوعي على عالمهم الروحي، وعلى دينهم وتاريخهم وثقافتهم. ويبدو أنها ما زالت تسيطر حتَّى اليوم على الرأي العامِّ عن العرب، من خلال تزييف التاريخ).
وإذا وقفنا عند إنجازات المجتمعات المسلمة في العصور الأولى في مجالات العلوم التطبيقية والبحتة والاجتماعية والنفسية؛ يظهر بعض المستشرقين منكرين لهذه الإنجازات ولمنجزيها، متجاهلين النهضة العلمية التي شارك فيها علماءُ ذلك الزمان من المسلمين وغير المسلمين، داخل مجتمعٍ كان يعجُّ بالتأليف والاختراعات والإبداعات في جوٍّ من السماحة الدينية، مصحوباً بالتشجيع على هذا من الخلفاء والأمراء والولاة والموسرين، مما هو معروف مبسوط في تاريخ العلوم عند المسلمين.
فيأتي كتاب تاريخ كمبرج للإسلام ويتغافل عن هذه الإنجازات الحضارية. ويسهم المستشرق النمساوي غوستاف فون غرونباوم (1909 - 1972م) في هذا التجاهُل، عندما يسم هذا العصر العلمي بأنه عصر اقتباس وتقليد للحضارات القديمة. حتى الأدب عنده من شعر ونثر كتبه الفرس.
مواقف إيجابية
هذا النوع من التجاهُل حدا ببعض المفكِّرين الغربيين أنفسهم إلى إنصاف المسلمين، وعدم الاستمرار في إنكار جهودهم وتضييع ممارساتهم في نقل الحضارة وصقلها والإضافة إليها، بحيث يُعتمد ما خلَّفوه بعدئذٍ من تراث خالد فيما لحق من مؤسسات علمية وبحثية. وأنه يظلُّ للمسلمين فضلٌ على العالم في الأبعاد الحضارية، النقيَّة من شوائب السحر والشعوذة المتوارثة في بعض الثقافات، بما فيها ثقافات العالم الغربي، كما تقرِّر المستشرقة الألمانية المنصفة زيجريد هونكه (1913 - 1999م).
وزيجرد هونكه المنصفة لتاريخ العرب والمسلمين هي التي تقول: (التاريخ يثبت ويؤكِّد أنَّ العرب بمؤلَّفاتهم العظيمة هم أساتذة أوروبَّا. وهذه الكتب قد استُخدمت قديماً لتخريج أطبَّاء بغداد وقرطبة. وهذه الكتب أيضاً هي التي تخرَّج عليها عددٌ كبيرٌ من الأجيال، سواء في العالم الإسلامي أو المسيحي الأوروبِّي، وبخاصَّةٍ في الطبِّ. فمؤلِّفو هذه الكتب العربية لم يكُن يخطر ببالهم أنَّ كتبهم ستجد هذا الإقبال وذلك الرواج). وهي نفسها صاحبة كتاب (التوجُّه الأوروبِّي إلى العرب والإسلام حقيقة قادمة وقدر محتوم).
هذه المواقف الإيجابية من التاريخ العربي الإسلامي القادمة من المستشرقين ليست وليدة هذا الزمان، كما يوحي به المرجعان أعلاه، بل إنَّ في الساحة الاستشراقية القديمة أعلاماً انبروا لإيضاح الوجه المضيء دائماً لتاريخ الإسلام والمسلمين. فهذا (شهيد التراث العربي) يوهان يعقوب رايسكه (1716 - 1774م) من أعلام الاستشراق الألماني في القرن الثامن عشر الميلادي، يقف وقفاتٍ واضحةً منافحاً عن المسلمين وتاريخهم وتراثهم المخطوط ويصف المخطوطات العربية بأنها أولاده، حيث لم يكن له أولاد.
ويلقى بسبب مواقفه هذه من التراث العربي الإسلامي العنت والهجران والإهمال من أترابه المعاصرين له الذين لا يُريدون الإنصاف ولا يسعون إليه، ومن السلطة القائمة في حينه. وله أتراب قبله وبعده خدموا التراث العربي الإسلامي.
وهذه المواقف الإيجابية تنفي لهجة التحامُل على المستشرقين بعمومهم. ويقتضي النقد الموضوعي الابتعاد عن التعميم في الأحكام، دون الانبهار في الوقت نفسه والتبجيل لإسهامات المستشرقين، وأنهم فهموا التاريخ الإسلامي أفضل من فهم المسلمين له! فالمنهج الوسط حريٌّ بأنْ يضع الأمور في نصابها.